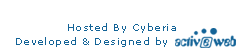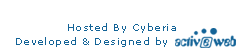نجيب صعب، كانون الأول 2020
قد تدخل 2021 التاريخ على أنها السنة التي شهدت التغلب على أخطر كارثة صحية في هذا العصر، عن طريق اللقاح، بعد وصول الجائحة إلى الذروة. فهل تشهد أيضاً عملاً دولياً جادّاً على جبهة التصدّي للتغيُّر المناخي؟ الفارق أنه إذا كان ممكناً وضع حدّ لفيروس "كورونا" بلقاح، فليس من لقاح سحريّ يوقف التغيّر المناخي.
يستقبل العالم سنة 2021 بمزيج من الانكسار والتفاؤل. فأبعد من آثارها الصحية المروعة المستمرة، التي أصابت نحو 100 مليون شخص وأدّت إلى وفاة أكثر من مليون ونصف المليون خلال سنة واحدة، ضربت الجائحة الاقتصاد العالمي ووضعت مئات الملايين خارج سوق العمل. وقد جاء تطوير لقاحات فعّالة وبدء توزيعها على نطاق واسع ليعطي إشارة بدء الخروج من النفق المظلم. ولا بدّ أن إرادة البقاء والتقدُّم ستنتصر في النهاية.
التحرُّر التدريجي من القيود الاجتماعية والاقتصادية التي فرضها الوباء سيعيد إلى دائرة الاهتمام الأولى التحدّي الأكبر الذي يواجه البشرية في هذا العصر، وهو التغيُّر المناخي. وستشهد سنة 2021 أهم قمة مناخيّة بعد قمة باريس عام 2015، التي تمخّضت عن اتفاقية استثنائية لخفض الانبعاثات الكربونية. وتوقّع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أن تكون 2021 "سنة مفصليّة للعمل المناخي"، وهو محقّ في هذا لأسباب عدّة. فالقمة المقبلة ستكون الفرصة الأولى لمراجعة ما تمّ إنجازه من الالتزامات الطوعية بموجب اتفاقية باريس. كما أنها تأتي مباشرة بعد جائحة كورونا، التي ترافقت فيها الأزمات الاقتصادية مع تخصيص موازنات ضخمة بمئات آلاف الملايين لخطط التعافي. وشهدت السنوات الماضية بعض أبرز الاكتشافات العلمية التي تؤكّد بما لا يقبل الشك تفاقم أخطار التغيّر المناخي، مما يستدعي تسريع وتيرة تخفيف الانبعاثات والوصول إلى "صفر كربون" قبل سنة 2050، مع تخفيض الحد الأعلى المقبول لمعدلات ارتفاع درجات الحرارة من درجتين مئويتين إلى درجة ونصف الدرجة. لكن الحدث الأهم الذي سيطبع قمة المناخ المقبلة هو خروج دونالد ترمب من السلطة ووصول جو بايدن إلى سدّة الرئاسة في الولايات المتحدة.
لقد تبنى ترمب سياسات متوحّشة، ألغت الكثير من قيود حماية البيئة داخلياً، وأخرجت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس المناخية، لمصلحة رفع حجم الدخل القومي وزيادة أرباح الشركات. وفي الداخل الأميركي، أبطلت إدارة ترمب مفاعيل نحو مئة قانون بيئي، فخففت القيود على التنقيب في قاع البحر، وتراخت في معايير تلوّث المياه والانبعاثات من محطات توليد الكهرباء ومستويات تلوث الهواء في مصافي البترول، كما سمحت بالتنقيب في المناطق المحمية ومرور أنابيب النفط والغاز عبرها.
الرئيس المنتخب جو بايدن أعلن صراحة في برنامجه الانتخابي أن إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس ستكون من أولى قرارات إدارته، إلى جانب إعادة تفعيل القوانين البيئية الوطنية. ومن أبرز القضايا البيئية التي التزم بها بايدن على المستوى الوطني إعادة فرض معايير مرتفعة على صانعي السيارات، من حيث الكفاءة في استهلاك الوقود والحدود القصوى المسموحة للانبعاثات، وتشجيع السيارات الكهربائية بتدابير ضريبية من حوافز وروادع، وتوسيع استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض الانبعاثات من مطامر النفايات، بما يستدعي تخفيف الهدر وتقليل كمية النفايات التي تصل إلى المطامر، ووضع قيود مشددة على انبعاثات الميثان المسموحة في عمليات النفط والغاز.
بالاستناد إلى الوعود الواضحة التي أعلنها بايدن، والتي لم يسبق لأي رئيس أميركي آخر أن التزم بمثلها، من المتوقع أن تتبوأ الولايات المتحدة الموقع الأوّل في قيادة العمل المناخي العالمي. ولن يقتصر هذا على خفض الانبعاثات الكربونية على النحو الذي يكفل عدم تجاوز ارتفاع الحرارة حدود الدرجة والنصف، بل الأهم الالتزام بالمساهمة في دعم الدول النامية بمئة مليار دولار سنوياً بين 2020 و2030، لمساعدتها في تخفيف الانبعاثات والتكيُّف مع المتغيرات التي لن يمكن وقفها.
المئة مليار دولار سنوياً، حتى لو سُدِّدت بالكامل، تبقى جزءاً بسيطاً مما هو مطلوب لعمل مناخي عاجل وفاعل. لكن آلاف المليارات التي تم تخصيصها حول العالم لخطط التعافي الاقتصادي من كورونا قد توفّر مخرجاً مناخيّاً أيضاً، وهذا يكون بتوجيه الدعم المالي نحو برامج اقتصادية تخفف من حدة التغيُّر المناخي. فالحلّ الأمثل هو في زيادة فرص العمل بالتوازي مع الحفاظ على سلامة البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية. وهذا هدف ممكن، لكنه يتطلب إرادة سياسية.
جو بايدن أعلن تخصيص مئات المليارات لتحسين كفاءة الأبنية في الولايات المتحدة، خاصة بالعزل الحراري والتحوُّل إلى الطاقات المتجددة، للحد من استهلاك الطاقة وتخفيف الانبعاثات. هذا برنامج يمكن تعميمه في بلدان العالم جميعاً، مع الدعم الملائم. كما يمكن تخصيص الجزء الأكبر من أموال التعافي لزيادة حصة الطاقات المتجددة وتخفيف الانبعاثات من وسائل النقل، وتطوير برامج التقاط الكربون وتخزينه أو إعادة استخدامه، التي أقرتها قمة العشرين في الرياض. ويمكن تخصيص جزء من أموال التعافي لإدارة أفضل للغابات والبحار والمناطق المحمية، وكلها تساعد في امتصاص الكربون. ومن البرامج المرشحة للتمويل إدارة النفايات، باعتماد مبدأ التخفيف وإعادة الاستعمال وإعادة التصنيع، ومعالجة المياه المبتذلة لإعادة استعمالها، فلا تُهدر نقطة واحدة. واعتماد أنماط الإنتاج الصناعي الأنظف، التي تقوم على تخفيف التلويث والهدر، بحيث يمكن إنتاج ما نحتاج إليه بنوعية أفضل وباستخدام كمية أقلّ من المواد الأولية. هذه كلها برامج تخلق وظائف تفوق بأضعاف تلك التي تحتاجها النشاطات التقليدية، فتساعد في التعافي الاقتصادي بينما تحافظ على سلامة البيئة وتحدّ من تغيُّر المناخ.
حين أُقرَّت اتفاقية باريس عام 2015، اعتبرها كثيرون ضعيفة وبلا جدوى، لأنها اقتصرت على التزامات طوعية بتخفيض الانبعاثات. لكن أهميتها تكمن في أنها تضمنت، للمرة الأولى، مبدأ مشاركة جميع الدول بتخفيض الانبعاثات، ولو وفق التزامات طوعية، مع مساعدة الفقيرة منها على تنفيذ التزاماتها، من خلال دعم مادّي وتكنولوجي. هذا كان انجازاً كبيراً، وفق المعطيات والظروف المتوافرة في ذلك الوقت. أما اليوم، فنحن في زمن آخر، تحكمه آثار جائحة كورونا والنتائج المترتبة عليها، كما التغيير البنيوي في السياسة الأميركية، إلى جانب الحقائق العلمية الدامغة التي ظهرت في السنوات الخمس الأخيرة، والانخفاض المتواصل في تكاليف الانتقال إلى تكنولوجيات منخفضة الكربون، مثل إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح.
في الذكرى السنوية الخامسة لاتفاقية باريس في 12 ديسمبر (كانون الأول)، عُقدت الأسبوع الماضي "قمة الطموح المناخي" الافتراضية، بمشاركة 75 رئيس دولة وعشرات من رؤساء المنظمات الدولية وقادة قطاع الأعمال والمجتمع المدني. وكان الهدف تقديم تعهدات جديدة لخفض الانبعاثات والتكيف. في كلماتهم، قدَّم 45 رئيس دولة التزامات وطنية جديدة بخفض الانبعاثات، بينما حددت 24 دولة تواريخ أقرب للوصول إلى هدف "صفر كربون" ، وقدمت 20 دولة خططاً جديدة للتكيف. هكذا يتجاوز عدد الدول التي التزمت بخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر قبل سنة 2050، عتبة الـ 70، على أن تعلن نحو 80 دولة أخرى التزامات مشابهة في المستقبل القريب. وقد ألزمت آلاف الشركات العالمية نفسها طوعاً بهذا الهدف. كل هذا كان خارج البحث حين عُقدت قمة باريس قبل خمس سنوات.
اللافت أن العرب كانوا شبه غائبين عن "قمة الطموح المناخي" الأسبوع الماضي. فالرئيس العراقي كان العربي الوحيد المشارك، وهو ألقى كلاماً عاماً حفل بالنيات الحسنة وافتقر إلى التعهدات. وفيما استفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي من المنبر الدولي لعرض الكثير من الوعود، خسر العرب فرصة أخرى لتقديم أنفسهم كشركاء فعليين في المساعي العالمية لمجابهة التغير المناخي.
المأمول أن تكون 2021 سنة التعافي من كورونا والتحوّل الجذري في العمل المناخي العالمي، الذي ستظهر نتائجه في قمة غلاسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ولكن، قبل ذلك التاريخ، نتوقع خطوات كبيرة وسريعة تعكس حراجة الموقف. فمزيد من الدول ستعلن وقف إنتاج وبيع السيارات العاملة على البنزين والديزل قبل سنة 2035، كخطوة ضرورية لخفض الانبعاثات. وستتحول شركات كثيرة إلى ممارسات وأساليب إنتاج تخفف من انبعاثات الكربون، وصولاً إلى إلغائها بالكامل، وذلك لحجز مكان لها في الاقتصاد الأخضر الجديد. وسيأتي التمويل المناخي من حيث لم يكن منتظراً، إذ بينما اختلفت الدول في قمة باريس وبعدها على كيفية توزيع عبء تقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول الفقيرة على خفض الانبعاثات، إذا بالأموال، التي تراوح من 10 إلى 20 تريليون دولار، وهي تساوي عشرين ضعفاً لما تم التعهد به لصندوق المناخ على فترة عشر سنين، تهبط كمساهمات في خطط التعافي من الجائحة. وقد وعدت معظم الدول، وفي طليعتها دول الاتحاد الأوروبي، بتوجيه هذه الأموال نحو الاقتصاد الأخضر. والأكيد أن "أميركا بايدن" ستتبعها في هذا المجال.
إلى أن يلتقي العالم في قمة غلاسكو، على العرب أن يستعدوا للمشاركة الفاعلة في العمل الجدي لتعافي كوكب الأرض من التدهور البيئي والتصدّي للتغيّر المناخي. فالأفعال وحدها تُثبت صدق النيات.
|